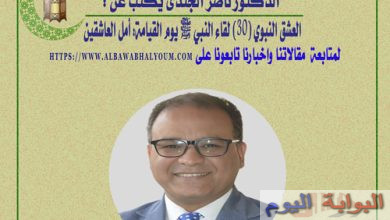النقد الجديد

دكتور/ أشرف إبراهيم زيدان
رئيس قسم اللغة الإنجليزية- كلية الآداب- جامعة بور سعيد
ظهرت مدرسة النقد الجديد في أوائل القرن العشرين (1920-1930) وبلغت ذروتها بين عامي (1950-1975)، قبل أن يتراجع تأثيرها مع ظهور نظرية “استجابات القارئ”. جاءت هذه المدرسة كرد فعل على عدة اتجاهات نقدية سابقة، منها نظرية أرسطو حول “التطهير” (Catharsis) الذي يمر به الجمهور في نهاية العمل الأدبي، والرومانسية التي تركز بشكل أساسي على المؤلف (Subjectivity)، بالإضافة إلى الانطباعية التي تربط تقييم العمل الأدبي بتأثيره الشخصي على الناقد، حيث يفضل الناقد ذو التوجه الديني، على سبيل المثال، الأعمال التي تدعو إلى الفضيلة ويرفض غيرها بوصفها غير أخلاقية. كما رفضت المدرسة النقدية الجديدة المنهج التاريخي والاهتمام بسيرة المؤلف.
بشكل عام، ترفض مدرسة النقد الجديد أي عوامل خارج النص، مثل سيرة المؤلف، السياق التاريخي، البعد الاجتماعي، الدين، أو استجابة الجمهور، وتركز على تحليل النص الأدبي ذاته بطريقة علمية موضوعية، مؤيدةً فكرة “لا شيء خارج النص” أو ما يعرف بـ”موت المؤلف”. ولتقريب هذه الفكرة، يمكن تشبيهها بمفهوم الزواج، حيث كانت المعايير التقليدية تشمل المال، الجمال، الحسب والنسب، وأخيرًا الدين، لكن وفقًا لهذا المنهج، يكون التركيز فقط على الشخص نفسه، بمعزل عن تلك السياقات الخارجية.
تتميّز مدرسة النقد الجديد بعدة سمات رئيسية، أبرزها اتباع المنهج العلمي في التحليل، والقراءة الدقيقة المتعمقة للنص. (Close Reading/Explication) كما تؤمن بمفهوم استقلالية النص (Autotelic Text)، أي أن النص قائم بذاته ولا يحتاج إلى معرفة حياة المؤلف أو الظروف التاريخية لفهمه، تمامًا كما أن المرأة المستقلة لا تحتاج إلى من يكملها.
ومن المبادئ الأساسية لهذه المدرسة أيضًا المغالطة المقصودة (Intentional Fallacy)، حيث لا يُعتمد على نية الكاتب في تفسير النص، بل يتم التركيز على تحليل النص علميًا بعيدًا عن مقاصد المؤلف. إضافة إلى ذلك، ترفض المدرسة تأثير القارئ على تفسير العمل الأدبي، وهو ما يُعرف بـ دور القارئ المتأثر بالنص (Affective Fallacy).
يركّز النقد الجديد على الشكل والمحتوى معًا، سواء على النص ككل أو على أجزائه، ويؤيد فكرة “الفن لأجل الفن” (Art for Art’s Sake)، أي أن القيمة الجمالية للأدب تكمن في ذاته، وليس في أي بعد خارجي. وأخيرًا، ترفض هذه المدرسة “بدعة إعادة الصياغة” (Heresy of Paraphrase)، حيث ترى أن إعادة صياغة النصوص تفقدها عمقها الأدبي الحقيقي.
يُعد ماثيو أرنولد من النقاد المؤثرين على مدرسة النقد الجديد، حيث استمدت منه موضوعية وحيادية النقد (Impartiality) في تحليل النصوص الأدبية. كما تأثرت المدرسة بأفكار الشاعر الإنجليزي ت. س. إليوت، الذي يرى أن الشعر هو هروب من الذاتية والمشاعر، مشبهًا عقل الشاعر بالمحفّز الكيميائي.
يشبه إليوت عقل الشاعر بعنصر البلاتين، الذي يعمل كعامل محفز في التفاعلات الكيميائية، بينما تمثل العواطف والمشاعر عنصري الكبريت والأكسجين. في هذا التشبيه، عندما يتم خلط الأكسجين بثاني أكسيد الكبريت بوجود خيوط من البلاتين، يتشكل حمض الكبريتيك. ومع ذلك، يظل البلاتين غير متأثر ولا يظهر أي أثر في الناتج النهائي، إذ يسهم فقط في تسهيل التفاعل دون أن يتغير. وبالمثل، يعمل عقل الشاعر كوسيط يدمج التجارب والمشاعر في العمل الفني دون أن يكون متأثرًا بها مباشرة. إلى جانب ذلك، رفض إليوت التركيز على جماليات النص (Aestheticism)، مثل الاستعارات والتشبيهات والمحسنات البديعية، ورأت أن الأدب يجب أن يستخدم “المقابل الموضوعي” (Objective Correlative)، أي التعبير عن العواطف من خلال رموز وأحداث موضوعية تجسدها وترتبط بها.
من بين الشخصيات البارزة في هذه المدرسة جي. إي. سبينجارين (J. E. Spingarn)، الذي يُعد أول من صك مصطلح “النقد الجديد” عام 1910. كما تأثرت المدرسة بـ مدرسة الهروب، التي فضّلت الزراعة على الصناعة وأولت اهتمامًا بالجوانب الرسمية للشعر.
أما آي. إي. ريتشاردز، فهو رائد ومؤسس النقد الجديد، وله خمسة كتب مهمة:
1. “معنى المعنى” (1923) – بمشاركة سي. كي. أوجدن، حيث بحث في فلسفة اللغة ودلالاتها.
2. “مبادئ النقد الأدبي” (1924) – تناول فيه الأسس النظرية لهذا الاتجاه النقدي.
3. “النقد العملي” – ركّز على القراءة الدقيقة والتحليل العلمي للنص، مع التركيز على الحواس، النغمة، المشاعر، والنية.
4. “فلسفة البلاغة” – ناقش فيه الأساليب البلاغية وتأثيرها في الأدب.
5. “كوليردج يدعمه الخيال” – استعرض فيه تأثير الخيال في النقد الأدبي.
أما الناقد ويليام إيمبسون (William Empson)، فقد أكد في كتابه الشهير “سبعة أنواع من الغموض” (1930) على تعددية المعاني التي يمكن أن يحملها النص الأدبي. استخدم استعارة إليوت “عصر الليمون”، حيث يرى أن كلما زادت محاولات تحليل النص، زادت المعاني التي يمكن استخلاصها منه، مما يجعل الغموض عنصرًا ثريًا يعزز البلاغة بدلاً من اعتباره نقصًا أو خللًا شعريًا.
ركز كلينث بروك في كتابه “Well Wrought Urn” (1947) على رفض إعادة صياغة القصيدة، مشددًا على أهمية تحليل النصوص الأدبية استنادًا إلى أمثلة ملموسة بدلًا من التعميمات.
أما روبرت بين وورن، فقد شارك في تأليف كتاب “فهم الشعر” (1938)، الذي ساهم في ترسيخ منهج النقد الجديد، في حين يُعد جي. سي. رانسم فيلسوف هذه المدرسة، وقد قدّم رؤيته النقدية في كتابه “النقد الجديد” (1941).
 من بين النقاد البارزين أيضًا وليام ك. ويزات ومونرو سي. بريدزلي، اللذان صكا مصطلحين رئيسيين في كتابهما “الأيقونة اللفظية: دراسات في معنى الشعر” (1982):
من بين النقاد البارزين أيضًا وليام ك. ويزات ومونرو سي. بريدزلي، اللذان صكا مصطلحين رئيسيين في كتابهما “الأيقونة اللفظية: دراسات في معنى الشعر” (1982):
1. المغالطة المقصودة (Intentional Fallacy) – وهي رفض فكرة أن نوايا المؤلف يجب أن تحدد التفسير الصحيح للنص، مؤكدين أن العمل الأدبي مستقل عن مؤلفه.
2. المغالطة العاطفية (Affective Fallacy) – وهو مفهوم يشير إلى خطأ تقييم النص بناءً على تأثيره العاطفي على القارئ، حيث يجب التركيز على التحليل الموضوعي بدلًا من الاستجابات الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، قدّم الناقد إف. آر. ليفيس إسهامات مهمة من خلال أعماله: “الموهبة العظمى” (1948)، “تقييم جديد” (1936)، و”معانٍ جديدة في الشعر الإنجليزي” (1932.(
وأخيرًا، أسهم الناقد ألن تيت في تطوير النقد الجديد من خلال صياغته لمفهوم “التوتر” في كتابه “رجل الأدب في العالم المعاصر: مقالات مختارة 1928- 1955 (1955) “، حيث ناقش التفاعل بين العناصر المتناقضة داخل النص الأدبي.
تعتمد مدرسة النقد الجديد على نموذج ثابت لتحليل القصيدة، يركز على عدة عناصر رئيسية، منها:
1. الرمز والتناقض: يتم تحليل الرموز في القصيدة وما تحمله من تناقضات. فمثلًا، يرمز البحر إلى الانفتاح، الاتساع، وعدم السيطرة، لكنه يصبح خاضعًا للنظام أثناء المد والجزر، مما يجعله متوقعًا وقابلًا للضبط. ويجسد هذا التناقض رؤية ألكسندر بوب، الذي يرى أن الإنسان هو سيد الكون وضحيته في آن واحد.
2. الغموض: يتم استكشاف أوجه الغموض في النص، مثل مقارنة مشاعر الإنسان بالبحر؛ فكما أن البحر يمكن أن يكون هادئًا وخاضعًا للتوقع، فإنه قد يكون أيضًا بريًا لا حدود له، مما يعكس طبيعة المشاعر الإنسانية المتقلبة.
3. التوتر: تحليل الصراع بين الإنسان والطبيعة، حيث قد يكون الإنسان تحت رحمة البحر في بعض الأحيان، لكنه قد يكون قادرًا أيضًا على السيطرة عليه، مما يخلق توترًا دراميًا داخل النص.
4. السخرية: يتم تسليط الضوء على المفارقات الساخرة، مثل بحث أوديب عن قاتل والده، في حين أنه هو القاتل دون أن يدرك ذلك.
5. الشخصية القدوة: (Archetypal Hero) دراسة الشخصيات الأدبية التي تمثل رموزًا عالمية، مثل سيزيف، الذي يجسد العبثية والصراع اللامتناهي، وهاملت، الذي يمثل الصراع الداخلي والتردد.
6. وحدة المعنى: التأكيد على أن النص الأدبي يمتلك بنية متماسكة متكاملة، حيث تتداخل جميع العناصر السابقة لتشكيل معنى موحّد ومترابط داخل القصيدة.
أخيرا، تعرضت نظرية النقد الجديد لانتقادات عديدة بسبب منهجها الصارم، الذي أهمل بعض الجوانب الأساسية في التجربة الأدبية، ومن أبرز أوجه النقد التي وُجّهت إليها:
.1 إغفال العاطفة والتجربة الإنسانية
على الرغم من أن النقد الجديد قدم أدوات تحليلية دقيقة للنصوص، إلا أنه تعرض للنقد بسبب تجاهله للعاطفة، التي تُعد جزءًا أساسيًا من الإبداع الأدبي. فالأدب، بطبيعته، ليس مجرد بناء لغوي أو شكل فني، بل هو وسيلة تعبير عن التجربة الإنسانية والمشاعر العميقة. لكن وفقًا للنقاد الجدد، فإن أي تفسير يستند إلى التأثير العاطفي للنص على القارئ يُعد مغالطة عاطفية (Affective Fallacy)، مما أدى إلى تقليص الدور الذي تلعبه العاطفة في فهم الأدب.
.2 إلغاء الوظيفة الاجتماعية للأدب
تجاهل النقد الجديد البعد الاجتماعي والسياسي للأدب، إذ ركّز فقط على البنية الداخلية للنص. ومع ذلك، فإن العديد من الأعمال الأدبية العظيمة تتفاعل مع القضايا الاجتماعية وتعكس واقع المجتمعات، وتؤدي دورًا في تشكيل الوعي الجمعي. لذلك، رأى النقاد أن استبعاد السياقات التاريخية والاجتماعية من التحليل يجعل النقد الجديد منفصلًا عن الحياة الواقعية، مما يجعله أداة تحليل جامدة وغير مرنة.
.3 تحويل الأدب إلى مادة تحليلية معملية
من أبرز الانتقادات التي وُجّهت لهذه المدرسة أنها تعاملت مع الأدب وكأنه تجربة معملية، حيث تم فحص النصوص بدقة علمية، كما لو كانت تجارب كيميائية، دون الأخذ في الاعتبار العوامل الإنسانية أو التأثيرات الثقافية المحيطة. هذا التوجّه جعل النقد الجديد يبدو تقنيًا بشكل مفرط، وأبعده عن طبيعة الأدب الحية والمتجددة.
.4 التركيز على الشعر وتجاهل الأنواع الأدبية الأخرى
ركز النقد الجديد بشكل أساسي على الشعر، وخصوصًا القصيدة الغنائية، حيث وجد منظّروه أن هذا النوع الأدبي يناسب أساليب التحليل الدقيقة التي يطرحونها، مثل القراءة الدقيقة.(Close Reading) ولكن هذا النهج أدى إلى إهمال الرواية، والمسرح، والقصة القصيرة، والنقد السردي، وهي أشكال أدبية لا يمكن التعامل معها بنفس المعايير التي تُطبَّق على الشعر. وقد اعتُبر هذا التركيز المحدود تقليلًا من أهمية الأنواع الأدبية الأخرى في فهم الأدب وتطوره.